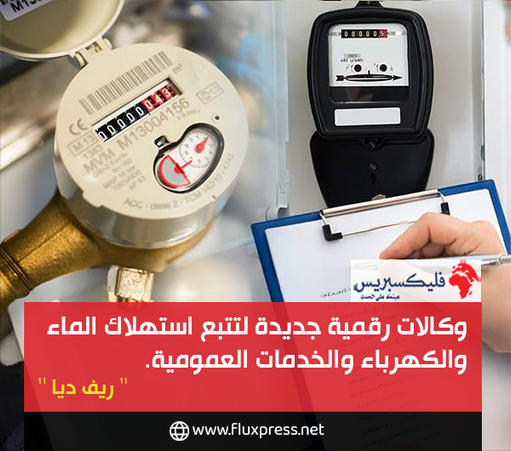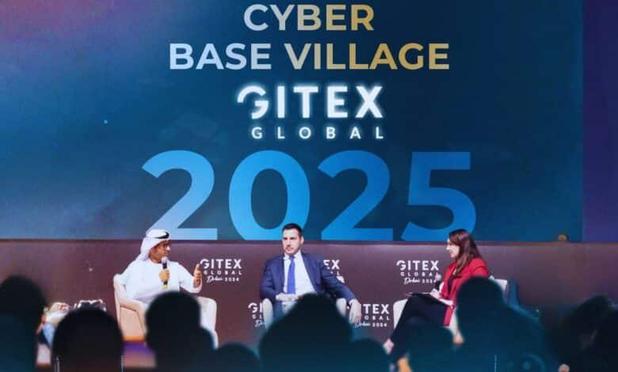التوأم الرقمي وثورة التيراهيرتز .. الدكتور نضال ظريفة يكشف ثلاثية تقنيات الجيل
السادس
من عالم الصبا البريء المُفعَم بالفضول، إذ كانت الأجهزة الإلكترونية لغزًا يستحق
التفكيك، إلى آفاق البحث العلمي المتقدّم في أرقى الجامعات الأوروبية، تمتد رحلة
استثنائية لمهندس وباحث سوري من طراز رفيع أراد أن يترك أثرًا يتجاوز جدران
المختبرات وردهات المؤتمرات الأكاديمية.
إنه الدكتور نضال ظريفة، الخبير في تقنيات الاتصالات المتقدمة في جامعة دوسبورغ
إيسن الألمانية، الذي نجح في حفر اسمه، بحروف من ذهب، ضمن فريق عمل معايير الجيل
الخامس العالمية، كما أنه ساهم في تأليف مرجع علمي رائد وهو لا يزال طالب دكتوراه،
في سابقة نادرة الحدوث.
ومن شغف التطبيق إلى حب البحث العلمي، ومن هندسة الإلكترونيات إلى آفاق والذكاء
الاصطناعي، تأتي هذه الرحلة لتثبت أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الرغبة في
المعرفة، وفي هذا الحوار الشامل والشائق الذي خص به، الدكتور نضال ظريفة ““، نكشف
أسرار مسيرته وسيرته من فتى دمشقي فضولي إلى باحثٍ دولي، ونغوص في رؤيته الثاقبة
بشأن كيف تشكّل “الثلاثية التكنولوجية” مستقبل اتصالاتنا، ولماذا يصر على مصطلح
“الذكاء الصنعي”، وكيف يمكن للشغف أن يبني جسورًا بين الطفولة والريادة العلمية.
بداية الشغف.. وإشكالية “الاصطناعي”:
في البدء، حدثنا عن رحلتك العلمية والمهنية، فما هي أهم المحطات التي شكلت توجهك
نحو قطاع الاتصالات والذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي، ولماذا تفضل مصطلح “الذكاء
الصنعي”، وما أهمية الشغف في تطوير المدارك العملية لدى الباحثين وطلاب العلم؟
منذ الطفولة بدأ شغفي بالأجهزة الإلكترونية ومحاولة إصلاحها التي كانت في الغالب
تؤدي إلى تخريبها بالكامل، لكن كنت أستمتع رغم هذا الفشل بتعلّمي أمرًا جديدًا ما،
فعلى سبيل المثال أذكر جيدًا، ذات مرة في طفولتي كنت أحاول إصلاح محول كهربائي
لجهاز صغير فلم أستطع، ولكني وجدت داخله شرائح حديدية ممغنطة، ووقتها انطبع في ذهني
أن بين المغناطيس والكهرباء علاقة ما، طبعًا لم أفهمها حتى الدراسة الثانوية.
وهوسي الإيجابي، إن صح التعبير، بالأمور التقنية استمر بشكل هندسي وتطبيقي وتعزز
بدخولي الجامعة باختصاص الإلكترونيات والاتصالات، بيد أن شغفي الحقيقي انتقل من
التطبيق إلى البحث العلمي في السنة الرابعة من الكلية إذ تعرّفت علم معالجة الإشارة
وهو بتعريف يسير: (الرياضيات التطبيقية المستخدمة في هندسة الاتصالات)، وقد نفذت
مشروع السنة الرابعة مع أستاذة المادة الدكتورة، مها الشدايدة، التي كان لها دور
محوري في تحولي من حب الهندسة كتطبيق مباشر إلى حب الهندسة كعلم وبحث علمي، وعندها
قررت التوجه إلى المجال الأكاديمي نظرًا إلى ما وجدته من أهمية لعلم معالجة الإشارة
ولضعف ومحدودية انتشاره في سوريَة مع أهميته الكبرى في البحث العلمي والهندسة
التقنية.
وأما رحلتي نحو التوأم الرقمي: فيمكن أن تحظى بفرصة لكن الاجتهاد هو الذي يحافظ
عليها، ففي عام 2015 حصلت على فرصة للعمل في مشروع أوروبي ضخم ومهم في تقنيات الجيل
الخامس ومن المفاجئ لي ترشيحي مديرًا لحزمة عمل جوهرية في المشروع، وبفضل هذا الدور
استطعت أن أدرج اسمي ضمن فريق عمل المشروع في معايير الجيل الخامس العالمية.
كذلك أتيحت لي الفرصة للمشاركة ضمن مجموعة باحثين لتأليف كتاب مرجعي هام في تقنيات
الجيل الخامس، وكان التحدي أنني استطعت إقناع المؤلف الرئيس بمشاركتي، مع أنني كنت
لا أزال وقتها طالب دكتوراه وهو أمر غير شائع.
وفي الجيل الخامس كان التطبيق النوعي المختلف عن الجيل الرابع هو (إنترنت الأشياء)،
إذ لم يقتصر المستخدم الرئيسي في الجيل الخامس على الإنسان وجهازه المحمول بل وصل
إلى الأدوات والأجهزة المختلفة المنزلية والصناعية والمؤسساتية.
وبعد تخرّج الجيل الخامس من مخابر الجامعة وبدء الأبحاث في تقنيات مرشحة لتشكيل
الجيل السادس، دخل مفهومان جديدان ثوريان في أنظمة الاتصالات:
* الاتصالات والاستشعار المتكاملان (Joint communication and sensing JCAS): إذ
نستعمل الموجة اللاسلكية نفسها، التي تُستخدم في الاتصالات لنقل المعلومات في
استشعار البيئة المحيطة، ورسم خريطتها، وتحديد مواقع الأجسام وحركتها.
* تقنية التيراهيرتز THz: يتيح العمل في هذه الترددات العالية جدًا (وهي تزيد ألف
ضعف على الترددات الحالية) في استشعار البيئة بنحو دقيق جدًا وإتاحة نتائج فعالة
في ذلك.
وترافق ذلك مع الصعود الكبير للذكاء الاصطناعي ودخوله كل المجالات ومنها أنظمة
الاتصالات على مستوى الشبكة نفسها وعلى مستوى التطبيقات وحالات الاستخدام، لذلك
شكّلت هذه الثلاثية التكنولوجيا اللازمة لتنفيذ مفهوم، وكما هو واضح من الاسم تهدف
تقنية التوأم الرقمي إلى تكوين نسخة رقمية للحالة الحقيقية بالزمن الحالي للجسم
المدروس (سواء كان شخصًا، أم منزلًا، أم مصنعًا، أم مشفىً، أم متجرًا،…) عن طريق
استشعار الوضع الحالي للأصل الفيزيائي ومراكمة هذه المعلومات على مدى طويل، ومن ثم؛
الحاجة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة كل هذه المعلومات وتسخيرها لمختلف
الأهداف: كتقييم الأداء، وتوقع المخاطر، وتحسين العمل، ورفع الفعالية، وما إلى
ذلك..
وعملي في هذه الثلاثية (الاستشعار اللاسلكي، والتيراهيرتز، والذكاء الصنعي) أتاح لي
العمل مع نخبة من العلماء الرواد في تقنية التوأم الرقمي وكذلك حضور اجتماعات كبرى
التحالفات التي تعمل في وضع معايير هذه التقنية على المستوى الصناعي والمؤسساتي
والطبي والتجاري وغير ذلك.
ونأتي الآن إلى مصطلح الذكاء الصنعي (Artificial Intelligence)، إذ يمكن تعريبه
(ذكاء اصطناعي)، لكنني لا أجد صيغة (اصطناعي / افتعالي) دقيقة في هذه الحالة؛ لأن
برأيي ذكاء الآلة في هذه الحالة هو ذكاء فعلي تجريدي تركيبي وتحليلي تعميمي.
ومع أنه ليس ذكاء إنسانيًا أو طبيعيًا، فإنه ذكاء فعلي ويقدر أيضًا على اتخاذ أفعال
بناء على ذكائه، وبناء عليه، أجد صيغة صنعي أقرب للدقة من اصطناعي كما أنها أسلس في
اللفظ وأسهل في الكتابة، ومع ذلك يبقى وجود مرجع للتعريب مع تفسير لغوي دلالي مقنع
هو الأمر الحاسم في هذا المصطلح وسواه.
وبالانتقال إلى مسألة الشغف لدى الباحثين: فبالطبع يشكل الشغف الدافع الرئيس لأي
نجاح مهني أو علمي، ففي البحث العلمي والجامعات يكاد يكون ذلك الإحساس هو الدافع
الوحيد لاستمرار الباحثين في عملهم، فحتى في الدول المتقدمة مثل ألمانيا والولايات
المتحدة، فإن العمل في القطاع الأكاديمي غير مجزٍ ماديًا إذا ما قارناه بما يمكن
للباحث أن يناله في القطاعات الصناعية والتجارية، لكن الشعور بأداء رسالة إنسانية
والرغبة في التعلم – التي لا تهدأ – تُعدّ هي الوقود الوحيد لآلة البحث والتدريس
عند الأكاديمي.
وشغفي بالتدريس يضاهي شغفي بالبحث العلمي، إذ دائمًا ما يكون لدي فضول عند عملي مع
الطلاب، وأما التحدي الأساسي الذي أضعه لنفسي، فمفاده: كيف يمكنني أن أُخرج منهم
أفضل طاقاتهم وأجعلهم نسخة متفوقة من أنفسهم معرفيًا...
🔗 https://aitnews.com/2025/10/24/خبير-الاتصالات-نضال-ظريفة-هذه-حلول-رد/
#5G #6G #الاتصالات #البوابة_التقنية #التحول_الرقمي #التوأم_الرقمي #الجيل_السادس #الذكاء_الاصطناعي #الشبكات #اللغة_العربية #سوريا #سورية #شبكات_الجيل_السادس